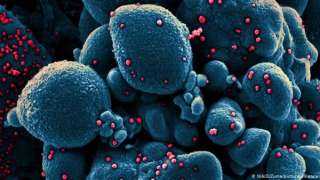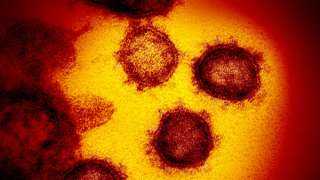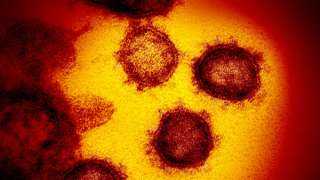ماذا يعني التفاؤل بزمن كورونا؟

لقد جاءت نكبة كورونا صدمة للعالم فعلاً، لا تتشائموا فما بعد كورونا ليس كما قبله. إن العالم أمام تحولات عميقة وكثيرة على كافة المستويات وبخاصة الثقافية والاجتماعية وضعت الانسان أمام تحد جديد وهو إلى أين يقودنا العلم؟ أنا حقيقة، لا أؤمن بنظرية أن العلم مسؤول في فعلته عن التطور وأنه لا حاجة للانسان الى الدين لانه لم يعد صالحاً للبشرية بفعل ما ارتكب باسمه من مجازر وحروب مثل التوحش والعصبيات والكراهية والتعصب والعنف والارهاب إضافة الى ذلك هناك إعتقاد عند البعض مفاده، أن العلم لم يقدم أجوبة على أسئلة الانسان بل اقتصر على طرح الاصول دون البحث في الفصول التي لم تلقبعدا انساني بقدر ماأحدثته ثورة التكنولوجيا والثورة الرقمية وثورة الانوار. من هنا كان لا بد من طرح هذا السؤال الذي عاد بإلحاح مع ظاهرة كورونا ليطرح معيلاً للبشرية بفعل ما وصل به الانسان أنانية طمع وتعالٍ وإفلاس قيمي وأخلاقي وتوحش. فما هو مصير الانسان بعد كورونا؟
لو نظرنا الى سُنن وقانون الطبيعة نجد أن العلم لم يخترع التقدم والتطور لانه مشهود به منذ بدأ التاريخ وتكوين البشرية. إن الفكرة ليست مسألة تطور بقدر ما هي مسألة تفاعل مع الظواهر وتفنيد تأثيراتها وتداعياتها على البشرية والمجتمعات وموقف الانسان منها. إن حقيقة التاريخ وتقدمه متصل بالأساس بعلم الاجتماع الانساني الذي هو عمران العالم وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الاحوال مثل التوحش والتأنسن وتقلبات البشرية على بعضها البعض لما يحمله الانسان بطبيعته من طبائع حوانية واستفراس عدواني وظُلمٍ، انطلاقاً من هذا، يأتي الموقف المعادي والمقاطع للدين كردّة فعل وليس كفعل على هذا الواقع. فكيف إذاً تفسرون من جهة القطيعة مع الدين ومن جهة أخرى العودة له بتشدد وأصولية كالاحداث التي شهدناها في أوروبا مع عودة الاصولية العلمانية والاصولية المسيحية وعلى خلفية الارهاب والاسلاموفوبيا.
أما فيما يتعلق بمسألة فيروس كورونا فهي بنظري حكمة يراد من خلالها توجيه رسالة الى العالم مفاده أن التقدم ليس وليد الحداثة ولو كانت معالمها قد اتضحت في فترة الحداثة، بل القول إن التقدم امتداده عميق في التاريخ ويعود ذلك الى الارث اليهودي-المسيحي للعالم الذي يقوم تصوره على احتقار العالم. وهذا الاحتقار هو الدافع إلى البحث عن عالم أفضل سياتي لاحقاً وهذا العالم هو الذي جاءت الحداثة لبلورة معالمه ووضع أسسه ومحاولة بنائه. حيث يقول ميشال مافيزولي، عالم الاجتماع الفرنسي في كتابه " زمن القبائل"، إن الظواهر الاجتماعية لا يمكن تفسيرها من الخارج من خلال اعتبارها كأشياء كما ذهب اليه إميل دوركايم، وإنما بفهم هذه الظواهر من الداخل من خلال إعطاء أهمية للحواس التي تبين أنه لا يمكن استبعادها من عمل السيولوجي ما أسماه مافيزولي ب(سوسيولوجيا الحواس)، ويؤكد أن العقل الانساني عندما يتجاوز سقفاً معيناً يصبح عقلاً مجادلاً، وهذا لا يعني التقليل من قيمة العقل لكن، هذا التجاوز أدى الى تجليات اجتماعية لا بد من التوقف عندها وهي ضعف الروابط الانسانية وانحسار الاشكال القديمة للتضامن ما ادى الى بروز ظواهر سلبية كظاهرة اللامبالاة وهي ليست ظاهرة فردية إنما ظاهرة جماعية، إذ أنها لا ترتبط ب(الأنا) وإنما ب(النحن)، التي جاءت ردفعل اتجاه عنف هذا العالم الذي نتج عن العولمة والرأسمالية المتوحشة والذي بات يتسم بشروط غير إنسانية وبسياسة ذات برامج غير فعالة، يسوده الكذب والنفاق.
وقد وردت هذه الادبيات في روايات البير كامو وعالم الاجتماع جورج زيمل حيث عبّرا فيها عن إفلاس العقلانية والعقل الذي لم يعد قادراً على أن يقود ويهيمن على حياة الناس ويوجه سلوكهم ومثال ذلك، سلبيات العالم الافتراضي وما يزخر به العالم المعاصر شاهد على ذلك.
من هنا يأتي كتاب " زمن القبائل" ليقول أن الفردانية ما بعد الحداثة قد استهلكت بما يكفي وظهرت بدلاً منها ذاتية جماهيرية اضحت عدواها تمّس تدريجياً كل مجالات الحياة الاجتماعية. مما يعني عودت القبائل بصيغتها الجديدةبإختصار وتنتقل من التمركز حول الذات الى التمركز حول الجماعة، كالسعادة والحس المشترك كالحجر الصحي مثلا (لا للحصر) حيث يقول ميشال سير إن الإنسان قد ألحق بالعالم خسائر فادحة تساوي الخسائر التي يمكن أن تترتب على حرب عالمية مثل فيروس كورونا حيث يدعو الانسان الى" التحكم في التحكم"، ومعنى ذلك التحكم في رغبتنا في التحكم في الطبيعةِ من خلال إيجاد علاقة حكيمة مع البيئة من خلال الفلسفة البيئية أو (الحساسية الايكولوجية).
ويذهب مافيزولي الى القول إن سمات الإنسان ما بعد الحداثة يطرح الحياة على أساس نظرية (اللحظة الخالدة)، أي لحظة الحاضر الآنية التي هي بلا هدف. وهذا الحاضر مبني على أساس الاستمتاع به الى أبعد حدّ ممكن حتى القبيح يتم تجميله، فيصبح أسلوبِ كل عصر محصلته تتميز بالتالي: عصر الوسيط كان أسلوبه لاهوتي، أما عصر الحداثة فساد فيه عصر اقتصادي، بينما في عصر الحداثة أو البيو-تقنية فيصبح أسلوبه جمالي حيث يبحث عن الجمال والفن والابداع وكلّ ما له علاقة بأعضاء الحواس، حيث يقبل الانسان ما بعد الحداثة الحياة كما هي، خذوا على سبيل المثال الكوارث البيئية التي حدثت في لبنان واستراليا والمترافقة مع الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي أُزيحت عن المشهد بحكم واقع فيروس كورونا المأساوية التي خيمت بظلالها على العالم ووحّدت البشرية حول تهديد وجودي مشترك وهو العدوى بهذا الوباء، مما فرض نفسه كشرا لا يتجزأ من نظام الكون، وأن الإنسان ما بعد الحداثة يقبل مصيره كيفما كان حيث أن الاحساس التراجيدي بالحياة يجعلنا نقبل بالشر بكل تجلياته ومن أبرزها الموت، فنجد بذلك فرحاً في الحياة.
إن عدم قدرة الإنسان في التأقلم مع ما تحدثه العلوم والعقلانية فرض مشاعر اللحمة التي تربط الافراد بعضهم ببعض إنطلاقاً من لحظات تعايش جماعي ما يؤدي الى دور جماعي نجد فيه الانسان المُحب للاخر الذي يمثل الابن الشرعي لما بعد الحداثة أي الحب لذاته وللاخرين وللطبيعة، وبكلمة واحدة إنه محب للكون، فلا تتفاجئ إن سمعت لاحقاً أصواتاً تنادي بحماية البيئة.
إن فكرة التعاطف هذه ستقودنا الى فكرة المشاركة من خلال الافتاح على الاخر والتفاعل معه ووض انفسنا مكان والتفكير من منظوره للاشياء ومحاولة الاحساس بما يحس به، وإن هذه الحضارة ستصبح "حضارة التعاطف" .
نعم ، كما سمعتم حضارة التعاطف مع الآخر من خلال الصور. لأن عالم الانسان ما بعد الحداثة، هو عالم من الصور حيث يعيش الانسان بالصورة وفي الصورة التي لا تجسد الواقع فحسب، بل إنها تخلق الواقع إيضا. وهذا العصر أي، عصر الصورة يساهم بظهور قيمة إجتماعية جديدة تتمثل بالاعلان عن الخاص الذي بات يستهلك على العام وفقاً لمخيلة عامة حيث كل شيئ يتحول الى صور. فإذا كانت المجتمعات القديمة تستهلك عقائد ، فإن المجتمعات المعاصرة تستهلك صوراً. وقد ترتب على ذلك نتائج إيجابية تتمثل في مجتمعات أكثر تحرراً وأقل تعصباً لكنها أكثر زيفاً وأقل أصالة. الشئ الذي أنتج في النهاية، عالماً واحداً لا تسوده اختلافات ولا تمايزات بعد ان كانت الصورة في التقليد الغربي والعربي شيئاً مخيفاً لانها فتنة وكراهية وتعصب، ونظراً الى التحولات التيعرفتها قيم المجتمعات تغيّرت هذه النظرة السلبية للصورة، مما أصبحت صلة وصل للعالم تربط العالم بالاخرين الذي تجسد فيها نزعة التيه من خلال رغبة الانسان في عدم البقاء منغلقاً على ذاته وحبهللإنفتاح على عوالم جديدة ومُعايشة تجارب الاخرين.
إن هذا التوجه لدى الإنسان نحو المغامرة والترحال اي، السفر فرض عودة الدين كعودة قوية وبنسخة معاصرة لما يمتلك من أدوات تمكِّنه من الـتأثير الروحي والسحري الذي يفرض طوطم وطقوس معاصرة تجسد فيه طوطم هذا الزمان بنزعة رومنسية من خلال بناء تصور جديد للعالم لما يختزن فيه من ذاكرة جماعية مرتبطة بعودة المكبوت بحسب تعريف سيغمود فرويد التي تتمحور حول الجسد والطبيعة والترفيه بمعنى الشبقي العاطفي أي، العيش مدارك اللحظوية - الانية من خلال تمجيد الرغبة والمتعة والجسد . إن هذه العودة للدين لا تعني العودة الى دين معين بل الى عودة اشكال منالتدّين الوثني المتمثل بإنفجار الهائل للصورة التي فيها عودة لحياة روحية ذات طابع حسيجماعي له معنى من خلال التمييز بين ما هو كائن وما يجب أن يكون.
أورنيلا سكر.. صحافية لبنانية وباحثة متخصصة في العلوم السياسية